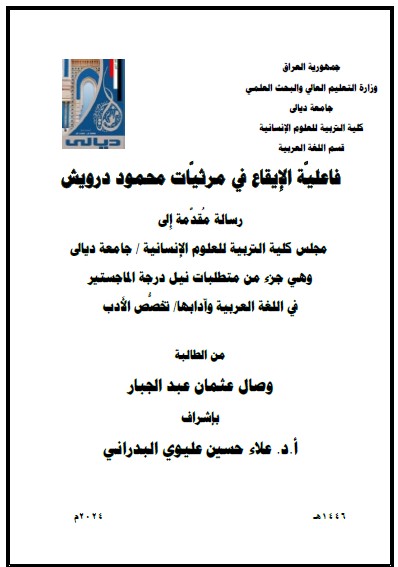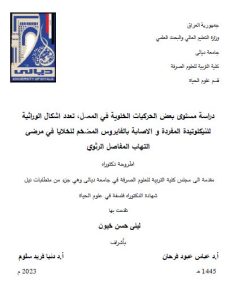المستخلص
فيُعدُّ الإِيقاع بنيَّةٌ فاعلة في النَّص الشِّعري؛ لما له من مساس بالمعنى النَّصي وبنَفَسِ الشَّاعر، فضلاً عن تأثيره في المتلقي، لذلك تنوَّعت أَبنيَّته وتنوَّعت دراساته النقديَّة، وبسبب ذلك جاءت رسالتنا لتستقرئ هذا المجال وتتبَّعُ مظاهره في نصوص المراثي عند الشاعر محمود درويش, فعُنيتْ بأهم ما تنتجه الفاعليّة الإيقاعيّة لقصائدِ الرِّثاء للشَّاعر محمود درويش، في التَّشكيل الجمالي اللغوي والمعنوي لبنية النّص الشّعري، والكشف عن القدرات الفنيَّة والإبداعيّة في تشكيل البنية الإيقاعيَّة والدِّلاليَّة، التي كانتْ محطَّةً للتأثيرِ والتأثُر المتبادل ما بين الشَّاعر والنِّص والمتلقي في دراسةِ الإيقاعِ الشِّعري في الأدبِ العربي بكلِّ ما ترفده بالجمالِ والتَّطور الثَّقافي الأدبي موسيقيًا بشكل عام، لذلك كانتْ دراستنا تسعى إلى الكشف عن مواطن الجمال؛ لرصد القيم الفنيَّة والإبداعية بذائقةٍ جماليَّة تستنطقُ ما جادتْ بهِ قريحة محمود درويش من دلالةٍ شعريَّة أغنتْ مرثيَّاته برونق التَّميز الذي استقاهُ من واقعِ القضية الفلسطينيّة التي كانتْ مدادهُ الممزوجِ بدمِ الشُّهداء وفقدِ الأحبَّةِ منَ الأهلِ والأصدقاء، فهي الرَّافد الذي ينهلُ منهُ عذوبة تجربَته الغنيَّة بشعريَّته العاليَّة.
وفي هذا الصَّدد تجدر الإشارة إلى أَنَّ لمنجزِ الشَّاعرِ الشِّعري حظًا وفيرًا من الدِّراسات في تشكيل البنيَة الإيقاعيَّة قد أفادتْ منها الباحثة وكان لها أَثرٌ في تخطِّي الكثيْر من الصِّعوبات إلا أَنَّ هذه الدِّراسات لم تتطرَّق إلى جانب الفاعليَّة الإيقاعيَّة في قصائد الرثاء، بلْ كان تَسَلُّطها على دراسةِ بعضِ الجوانب الفنيَّة والموضوعيّة، ومن هذه الدراسات: (البنية الإيقاعيَّة وتأثيرها في المعنى- محمود درويش أنموذجًا) للدكتورة سعدية مصطفى محمد .
وبخصوص اختيار الموضوع فإنَّها رغبة تولَّدتْ عندي بعد الاطِّلاع على متون الشِّعر الحديث فوقفتُ عند الطّروحات النقديّة الإيقاعيَّة وتلمّستُ أثرها في تأسيسِ مسار المعنى الشّعري بتشّكلاته المتنوّعة, وقد أيّد توجهاتي الأستاذ الدكتور إياد عبد الودود الحمداني فطرح عليّ عنوان: ( فاعليّة الإيقاع في مرثيّات محمود درويش), وبعد الاطّلاع والمفاتشة للنّماذج والقراءة الخاصّة والاستشارة العلميّة أقبلت إليه برؤية بحثية على وفق الإحاطة بالعنوان وأبعاده وتمفصلاته، ومن المهمّ ذكره أنّ العنوان يتناسب وتوجهاتي في الكتابة الشعريّة التي لمّا أزل أكتب على مقربة من هذا العالم، فضلاً عن الدّعم الذي حصلت عليه من أساتذتي للتوجّه إلى ما يزيدني معرفة من تجربتي في الكتابة ومحاولاتي المتواضعة, فكانَ تأسيسُ الدراسة يَنطلقُ من السؤالِ الذي أسهم في محاولةِ الكشف عن مدى فاعليَّة الإيقاع من حيثِ التَّأثير والتَّأثر في المتلقي عن طريق علاقةِ الدَّلالة بالنَّص، وما هي الجماليَّة التي يمكنُ أنْ تُحقِّقها الفاعليّة بوساطة الحركة الإيقاعيّة في قصائد الرِّثاء عند محمود درويش؟ وهل لهذه الفاعليَّة دور في إثارةِ الجانب الانفعالي لدى المتلقي بما تحملُ من معانٍ وصور شعريَّة ومعجم شعري؛ فيشارك الشَّاعر في تجربته الإبداعية؟ هذه التَّساؤلات وغيرها كانتِ الأساس الذي بُنِيتْ عليه مادّة الرِّسالة ومنطلقها البحثي .
تضمنت رسالتي ثلاثة فصول سبقها تمهيد، وتبعتها خاتمة كشفت عن أهم النتائج والملاحظ العلمية المشتقّة من الرُّؤية الشّمولية, تناولتُ في التَّمهيد الذي وسِم بـ (مفاهيم تأسيسية) مفهوم الفاعلية ومفهوم الإيقاع و الإيقاع والدلالة الشعرية وتحوّلات غرض الرّثاء, أمّا الفصلُ الأوَّل فقد جاء بعنوان (الفاعليَّة العروضية)، فتضمَّنَ ثلاثةِ مباحث، اشتمل المبحثُ الأوَّل على توطئةٍ لمفهوم الزُّحافاتِ والعلل وطريقة توظيفها في الأوزان الشّعرية، والمبحث الثاني تضمَّن فاعليَّة التَّنوِّيع التَّقفوي في دراسة قصائد (شعر التَّفعيلة)، وبيَّنت الباحثة أنماطها وما يترتَّب عليها من جماليَّة إبداعيَّة ميزتها عن الشِّعر العمودي، أمّا المبحثُ الثّالث فكان عن فاعليّة الإيقاع البَصَري التي تميَّزت بها قصائد درويش بإبداعه الفنِّي الذي شغلَ انتباه المتلقي عن طريق مساحة البياض التي مثلَّت صمتُ الشَّاعرِ والسّوادُ مثل تدفق نَفسهُ الشِّعري أثناء تجربته الشِّعرية في توظيفِ هذا النَّوع من الإيقاع, كما وسّمَ الفصل الثّاني بــ (فاعليّة الإيقاع الداخلي) وقد قُسِّمتْ الدراسة فيه على أربعةِ مباحث، جاء الأوَّل موسوما بـ (فاعلية التكرار وأنماطه)، التي أسهمتْ في إثراء البنيَّة الإيقاعيَّة بموسيقى جاذبة لإحساس القارئ والسامع، أمَّا المبحثُ الثَّاني فقد وسم بـ (فاعليّة التَّدوير) فقد احتوى على أنماطهِ التي بيَّنت أسلوب الشَّاعر الموسيقي وجماليَّة الفاعليَّة الإيقاعيَّة في توظيفه لها، والمبحثُ الثَّالث (فاعليّة الجناس)، وأمّا الرابع فقد وسُم بــ (فاعليّة التَّوازي )، بيَّنتُ أثره في رفد قصائد الرِّثاء بفاعليَّة إيقاعيَّة تُجمّل القصيدة عن طريق شحن السّطور الشِّعرية بحركة إيقاعية تتوائم مع دفقةِ النَّفَس الشِّعري للشاعر وتسهم في سبكِ سطورِ القصيدةِ وإثارة شعور المتلقي وإشغاله بإكمال قراءته لها بتمعن جمالي, أمَّا الفصل الثَّالث فجاء ليدرس التَّحكُّم الإيقاعي بتمظهرات معنويّة فوسِّم بـ (التَّحَكُّم بالإيقاع وتمظهراته المعنويّة), وقد جاء بمبحثين: وسم الأول بـ (التّنوُّع في الأَوزان)، وقد جاء مبنيًا على تعدُّد الأوزان وكيفية تنقل الشَّاعر من وزن إلى آخر في القصيدة الواحدة منتجًا فاعليّة إيقاعية أظهرت القدرات الفنيَّة والإبداعيّة التي تميَّزَ بها درويش، أمّا المبحث الثاني فقد وسِّم بـ ( ظاهرة التَّناوب ) سعيناً فيه لتوضيح طريقة تناوب الشَّاعر في توظيف الأوزان الشِّعرية بين الشَّكلين الشّعر العمودي والحرّ وكيفية تنقله من شكل إلى آخر عبْر احتياجه لهذا النَّوع في ضوء تجربته، وقد اعتمدتُ في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي وجدناه مناسباً في الكشف عن فاعلية الإيقاع في قصائد الرِّثاء, وفي هذا السياق حري بالذّكر الإشارةِ إلى أنَّ جهدي البحثي اقتضى أنْ أبحث عن دراساتٍ مشابهة في الاشتغال العلمي بوساطة قصائد درويش الرِّثائية في دراسات لا تنتمي إلى عنوان دراستي؛ حتَّى لا أقع في شراك السَّرقة العلمية؛ فرأيتُ أنْ أوظف هذه النّصوص مع الإشارة إلى جهد الباحث وإضافة ما يلاءم التَّحليل من أفكار تتناسب مع دراستنا وتطويراً لما وجدت الباحثة.
ولمّا كان لكّل مواجهة كتابية وصعوبات يواجهها الباحث فإِنَّ هذه الرِّسالة قد مرّت بصعوباتٍ عدّة واجهتنا، أهمها طبيعة المرحلة الأولى وبواكير الكتابة ومواجهة النّصوص الشِّعرية والطُّروحات البحثية واستخلاص رؤية خاصة بي، فضلاً عن مادة الإيقاع نفسها التي هي مادة دقيقة والولوج إليها يتطلب جهداً واسعًا وثقافة مسبقة، إلا أَنَّني بفضل الله تعالى وعونه تجاوزت ذلك لأَنتهي إلى ما انتهيتُ إليه بهذا السِّفر راجية تمامه إلى الحد الذي يفيد منه مَن يأتي بعدي من الباحثين ليضيف للمكتبة النقدية شيئا نافعًا.