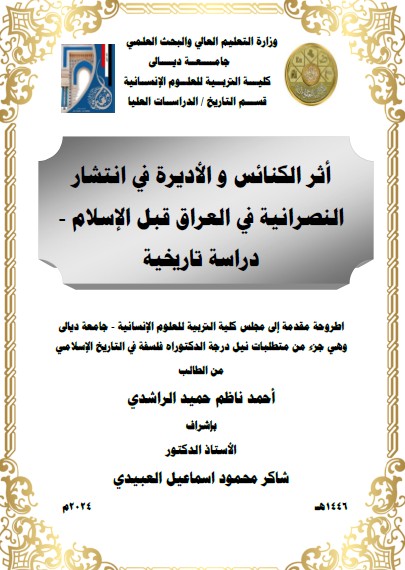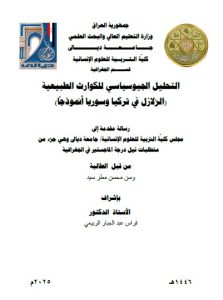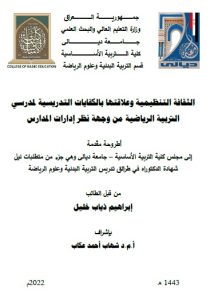المستخلص
المقدمة: نطاق البحث وتحليل المصادر :
الحمد لله القائل:ﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ ([1])، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمدr وعلى اله وازواجه وذريته وصحبه اجمعين.
وبعد.. فأن المتداول والمعروف بين المؤرخين ان حياة الخليقة بعد الطوفان استمرت من جديد في ارض الرافدين وهذا ما اشار اليه المسعودي (ت346هـ/ 957م) بقوله: “كان الناس بعد الطوفان مجتمعين في مكان واحد بأرض بابل”([2])، ومن هنا تبرز اهمية العراق في نشأت اولى الحضارات في تاريخ البشرية وشكلت ارضه محوراً مهماً لانتشار الكثير من الرسالات السماوية لاسيما الديانة النصرانية منها .
ولا نجافي الحقيقة اذا قلنا ان الديانة النصرانية وسمو تعاليمها لاقت رواجاً كبيراً في اغلب ارجاء ارض العراق بفضل الكنائس والاديرة التي اتخذها العلماء والرهبان والمبشرين والنساك اماكن للعبادة ونشر تعاليم الديانة النصرانية.
وفي ضوء ما تقدم وقع اختيارنا على دراسة موضوع اثر الكنائس والاديرة في نشر النصرانية في العراق قبل الاسلام، والطرق التي سلكها النصارى من خلال هذه الكنائس والاديرة في نشر النصرانية، اذ انها كانت اماكن عبادة مقدسة لدى النصارى، ومراكز دينية وثقافية وحضارية اثرت بمحيطها الجغرافي في مجتمع كان اغلبه يعبد الاوثان. فضلا عن ذلك فإن هذه المراكز كانت تقوم بوظائف عديدة اذ انها تأوي المجتازين بها ليلاً وتقدم العلاج للمرضى وغيرها من الوظائف الاخرى بالإضافة الى وظيفتها الاساسية وهي العبادة. وهنا تكمن اهمية الدراسة في استجلاء اثر الكنائس والاديرة في نشر النصرانية في العراق قبل الاسلام.
وبحسب اطلاعنا وطوال مدة الدراسة لم نجد هناك من كتب عن هذا الموضوع بصورة علمية اكاديمية متكاملة غير ان هناك دراسات اخرى قريبة من موضوعنا ومنها النصرانية عند الغساسنة والمناذرة للباحث غسان عبد صالح للعام 2000م، جاء فيها دراسة عن الحيرة وسكانها وديانات اهل الحيرة بالإضافة الى تعداد اديرة الحيرة . ومن الدراسات الاخرى هي الديارات النصرانية في العراق ونشاطاتها العلمية والفكرية حتى نهاية العصر العباسي للباحثة حنان عبد الرحمن طه الملا عام 2005م، وشملت هذه الدراسة عوامل ظهور الديارات واقسامها وسكانها، غير انه لا يوجد فيها تعداد لأي من كنائس واديرة العراق واثرها في انتشار النصرانية في العراق القديم.
ومن الدراسات الاخرى هي اديرة الحيرة قبل الاسلام واثرها في تطور الفكر المسيحي، للباحث ليث محمود عبود زوين عام 2012م، والتي درست الحيرة من حيث الاسم والموقع بالإضافة الى التكوين السكاني للحيرة والمعتقدات الدينية لسكانها وجاء فيها ايضا تعداد لأديرة الحيرة. وهناك دراسة اخرى مقاربة الى موضوعنا وهي الاديرة والكنائس المسيحية في مملكة الحيرة في ضوء المصادر التاريخية والتنقيبات الاثرية حتى نهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي للباحث نبيل عبد الحسين راهي عام 2016م، والذي احتوت على العمق التاريخي والتكوين السكاني والاجتماعي لمدينة الحيرة بالإضافة الى تعداد اديرة الحيرة وكذلك بعض الكنائس التي كانت في الحيرة.
في حين ان موضوع دراستنا جاء مغايراً مما ذكر في اعلاه وان كانت هناك بعض المشتركات بين هذه الدراسات ، وهذا ما كان له اثر في نفسي للاستزادة والاحاطة في بيان مدى الاثر الذي لعبته الكنائس والاديرة في نشر النصرانية في عموم العراق قبل الاسلام، وعدم الاقتصار في منطقة معينة.
لم تخلُ الدراسة من صعوبات املتها علينا طبيعة البحث ، ولعل ابرزها اتساع المدة الزمنية التي شغلتها فترة العرب قبل الاسلام، فضلاً عن سعة المادة في الفصلين الاول والثاني وهو ما حتم علينا الاحاطة بكل جوانبها، وما كان يقابلها احياناً من شحة المادة في الفصلين الثالث والرابع، مع قلة المصادر الاولية، اذ اننا لم نجد كتاب خاص او تفصيل خاص عن كنائس العراق انما كانت مبعثرة في متون المصادر مما حتم علينا تتبعها في متون الكتب، وكذلك في الفصل الرابع اذ واجهتنا صعوبات عن قلة المادة العلمية التي ذكرت الاديرة وخاصة اديرة شمال العراق ، ومن الصعوبات الاخرى التي واجهتنا هي ان المصادر الاولية لم تعط تفصيل واضح عن الكنائس او الاديرة او متى تم بنائهما، فان تحديد زمن بناء الكنيسة او الدير هي من اصعب المشاكل التي واجهت الباحث.
ولكي نعطي صورة واضحة ومتكاملة عن اثر الكنائس والاديرة في انتشار النصرانية في العراق قبل الاسلام اقتضت طبيعة الدراسة تقسم الاطروحة الى اربعة فصول سبقتها مقدمة تطرقنا فيها لأهمية الموضوع وتحليل لأهم المصادر والمراجع، وتلتها خاتمه اجملنا فيها اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة واعقبتها قائمة المصادر والمراجع وملخص الأطروحة باللغة الانكليزية.
تناولنا في الفصل الاول النصرانية واهم فرقها، وشملت كل من تعريف النصرانية لغة واصطلاحا، بالإضافة الى ولادة النبي عيسى(u) وكيف حملت به امه مريم بنت عمران(عـّـلُيـ,ـهّـاً اًلُسـ,ـلُاًمِّ) وجاء فيه ايضا بعض القاب النبي عيسى(u) ورسالته الى بني اسرائيل وكذلك النصرانية بعد النبي عيسى(u) وما حدث لها من تحريف الاناجيل الاربعة، والفرق النصرانية سواء كانت فرق موحدة او فرق عصر التثليث، وتطرقنا الى اساليب انتشار النصرانية وما تعرضت لها من اضطهاد من قبل اباطرة الروم.
وخصص الفصل الثاني في الافكار والمعتقدات الدينية السائدة في العراق قبل وبعد انتشار النصرانية فجاء فيه، موقع العراق القديم والعصور التاريخية التي مرت على ارضه وان اول حضارة في التاريخ كانت قائمة في العراق، بالإضافة الى ما كان سائد في العراق من افكار ومعتقدات وكيف ان العراق عرف التوحيد منذ زمن النبي نوح(u) الى ان تحولت ديانة اهل العراق بمرور الوقت الى عبادة الاوثان وان اصحاب اول حضارة في العراق هم السومريون كانوا عبدة اوثان، وفي ظل هذا التحدي ايضا كانت هناك دعوات توحيدية في زمن النبي ابراهيم(u) وانه دعا الى توحيد الله عز وجل في زمن ملك بابل النمرود، وجاء ايضا في هذا الفصل الفرثين والبدايات الاولى للنصرانية في العراق وكيف دخلت النصرانية الى العراق في القرن الاول الميلادي والطرق التي اتبعها المبشرون من جل تحقيق ذلك الى ان نمت النصرانية في العراق واصبح لها موطئ قدم، وصولاً الى سيطرة الساسانيين على العراق وما واجهت النصرانية من اضطهاد في تلك الحقبة الى ان توسعت في العهد الساساني واصبحت الحيرة من اهم معاقل النصرانية في العراق قبل الاسلام.
اما في الفصل الثالث فقد استعرض الباحث اثر الكنائس في انتشار النصرانية في العراق قبل الاسلام فبينا مفهوم الكنيسة لغةً واصطلاحاً واقسامها ونشأتها وكيف ان اول امرها كانت عبارة عن بيوت بسيطة اضيفت لها بعض التعديلات لكي تصبح اماكن للعبادة وذلك لان الوضع لم يكن يسمح للنصارى بأنشاء الكنائس وذلك بسبب ما كانوا يتعرضون له من اضطهادات مستمرة، الى ان حل القرن الثالث والرابع الميلاديين فقد ظهرت في تلك المدة بنايات مستقلة خاصة بالنصارى من اجل العبادة بعد ان أمنَ النصارى على انفسهم.
وثم بحثنا في هذا الفصل الادارة الكنسية داخل الكنيسة ورجال الدين ومراتبهم والقابهم، وكذلك ما يكون داخل الكنيسة من طقوس وعبادات، وبينت الدراسة اثر الكنائس في نشر النصرانية في العراق قبل الاسلام وكيف ان النصارى اخذوا على عاتقهم تشيد تلك الكنائس والتي كانت اغلبها على النسطورية اذا ما استثنينا مدينة تكريت والتي كانت على المذهب اليعقوبي وختمنا هذا الفصل بتعداد كنائس العراق وبينا اثر كل كنيسة ودورها في نشر النصرانية في العراق قبل الاسلام.
وخصص الفصل الرابع لدراسة اثر الاديرة في انتشار النصرانية في العراق قبل الاسلام، وبينا مفهوم الاديرة لغةً واصلاحاً وكذلك اقسام الدير بالإضافة الى نشأة الدير وكيف ان الديارات كانت في اول امرها مكان للانقطاع والعبادة وان الرهبنة هي الاساس في نشأة الدير وذلك للانقطاع عن الناس في مكان معزول في الصحاري او الجبال او الاماكن المنعزلة عن الناس الى ان اصبحت الحاجة ملحة الى انشاء مكان يجمع بين العبادة والانقطاع فتم تأسيس الدير واصبح فيما بعد قرب القرى والمدن وعلى ضفاف الانهار وفي السهول والبوادي وكان له وظائف عديدة غير العبادة اذ انها تأوي المجتازين بها ليلاً وتقدم العلاج للمرضى وغيرها من الوظائف الاخرى. وانتهت دراستنا في هذا الفصل ببيان مدى اثر هذه الاديرة في نشر النصرانية في العراق قبل الاسلام، وتعداد لاديرة العراق قبل الاسلام وتوضيح الاثر الذي تركته هذه الاديرة في نشر النصرانية.
تحليل المصادر:
نظراً لاتساع نطاق الدراسة وتعدد ميادينه في محاولة منا لتغطية جوانبه وإعطاء صورة وافية عنه فقد اعتمدت دراستنا هذه على جمله كبيرة من المصادر والمراجع الحديثة وسأقتصر بالوقوف على ذكر المهمة والرئيسة منها للتعرف على مدى اهميتها وفائدتها للبحث:
اولاً: كتب التاريخ العام :
شكلت كتب التاريخ العام مادة مهمة لدراستنا وخاصة في الفصلين الاول والثاني ويأتي في مقدمتها كتاب ” تاريخ الرسل والملوك ” للطبري ( ت 310ه/ 914م )، فهو يمثل قمة ما وصل اليه كتابة التاريخ عند العرب المسلمين، واستهل مصنفه بتاريخ الخليقة ثم تناول تاريخ الرسل والملوك في القدم وارخ بعد ذلك للساسانيين والعرب ثم تناول الاحداث حتى سنة 302ه، اما اسلوبه فهو يرد عادة اكثر من رواية للحدث الواحد ، ويبدي حيادياً واضحا فيما يورد من روايات تاركاً حرية الاختيار للباحث.
وقدم لنا الطبري معلومات مهمة اغنت البحث ولاسيما في الفصل الاول والثاني.
وامدنا كتاب ” البدء والتاريخ “ للمقدسي (ت بعد355ه/965م)، بمعلومات مهمة في الفصلين الاول والثالث، فهو احد المصادر التاريخية المهمة والذي يتكون من ستة مجلدات وقد استهل مصنفه بتاريخ الخليقة وما يتبعه من قصص الانبياء (عليهم السلام) واخبار الامم وتواريخ الملوك.
ورجع الباحث الى كتاب “المنتظم في تاريخ الملوك والأمم” لابن الجوزي(ت597ه/1200م) وهو من الكتب التي اشتمل على ترجمة ما يزيد من 3370 ترجمة ويعد اول كتب التاريخ التي جمعت بين الحوادث والتراجم وكان له الفضل في تغيير اسلوب كتابة التاريخ فاصبح من اسلوب السرد غير المنسق الى اسلوب منسق ملتزم بمنهج يسير فلا يسهب في سرد الحوادث ويهمل التراجم والعكس، ولكن يعطي لكل من الجانبين ما يستحق.
وتناول ابن الجوزي في كتابه التاريخ العام من بدء الخليقة الى سنة 574ه ويقع هذا المصنف في ثمانية عشر جزءاً تناول فيه التاريخ العام وكذلك ما يخص النبي عيسى(u) والنصرانية.
ومن المصادر التي اعتمدناها في دراستنا كتاب “البداية والنهاية” لابن كثير (ت774ه/1372م) وهو عرض للتاريخ رتبه على الحوليات منذ بدء الخليقة حتى سنة 768ه وتناول خلق السماوات والارض وخلق ادم(u) وكذلك قصص الانبياء، وكانت اهمية كتب التاريخ محصورة في الفصل الثاني .
ثانياً: كتب الجغرافية والبلدان :
تعد كتب الجغرافية والبلدان ذات قيمة كبيرة في مجال دراستنا وذلك من خلال الترابط الدقيق بين التاريخ والجغرافية فهي لا تقل اهمية عن قيمة كتب التاريخ وقد امدتنا هذه المصادر بمعلومات كثيرة طوال مدة الدراسة وعلى جميع فصول الاطروحة وذلك من خلال تعريفات المدن والبلدان الواردة في هذه الدراسة وكان لها ايضا قيمة دراسية في الفصل الرابع اذ انها ذكرت الكثير من اديرة العراق ويأتي في مقدمتها كتاب “الديارات” للشابشتي ( ت 388ه/998م )، وهو من ابرز كتب الجغرافية والبلدان والذي اختص في ذكر الديارات سواء كانت في العراق او الشام والجزيرة ومصر، وجمع الاشعار المنقولة عن كل دير وما جرى فيه من احداث، اذ يأخذ كتاب الديارات القراء في جولة الى الاديرة النصرانية اذ انه يوصف الاديرة وصفاً دقيقاً سواء كان عن موقعه او سبب التسمية وكذلك يقدم لنا قصائد وحكايات تاريخية تتصل بكل دير، وكانت قمة الاعتماد على هذا الكتاب في الفصل الرابع وذلك من خلال ما اورده عن ديارات العراق.
واستفادنا في هذه الاطروحة من كتاب “معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع” للبكري ( ت 487ه / 1094م ) والذي وصف فيه جزيرة العرب وما فيها من المعالم والمشاهد والاثار من المنازل والديارات والقرى والامصار وقد امدنا هذا الكتاب بمعلومات مهمة طوال مدة الدراسة وخاصة عن اديرة العراق.
ورفد كتاب “معجم البلدان” لياقوت الحموي ( ت 626ه / 1228م ) هذه الدراسة بمعلومات غزيرة، وهو من المصادر الجغرافية المهمة والذي قدم وصفاً دقيقاً للبلدان والانهار والديارات بصورة بليغة، وسهل ياقوت الحموي على الباحثين طريقة الاستفادة من مصنفه اذ انه رتب معلوماته على الحروف الهجائية، وكان لهذا الكتاب اهمية في اغناء هذه الاطروحة في كثير من جوانبها ولا سيما من خلال ذكره لبعض الديارات.
ومن الكتب التي اعتمدناها في هذه الاطروحة كتاب “اثار البلاد واخبار العباد” للقزويني ( ت682ه / 1282م ) وهو احد المعاجم الجغرافية المهمة التي احتوت على الكثير من الاحداث التاريخية، وان الكتاب فيه ثلاثة مقدمات جاءت المقدمة الاولى في الحاجة الداعية الى احداث المدن والقرى، وتطرق في المقدمة الثانية الى خواص البلاد وتأثير البيئة على السكان والنبات والحيوان، كما عرض في المقدمة الثالثة اقاليم الارض المعروفة آنذاك وقسمها الى سبعة اقاليم وعرض خصائصها، ويضم هذا الكتاب ايضا اخبار الامم وتراجم العلماء والادباء والسلاطين.
ثالثاً: كتب التفسير :
التفسير: علم يفهم به كتاب الله(U) المنزل على نبينا محمدr)) من حيث نزول الآيات واسبابها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها ، ويأتي في مقدمة كتب التفسير التي استفدنا منها كتاب “جامع البيان عن تأويل القران” للطبري(ت310ه/922م ) والذي يعد من هم كتب التفسير الذي لم يصنف مثله بالمأثور ويقع في ثلاثين جزء بدأ في املائه سنة 283ه / 896م وانتهى منه سنة 290ه / 902م وهو من اجل التفاسير واعظمها لما حواه من روايات كثيرة عن معنى كل اية بما يرويه بسنده الى الصحابة او التابعين، واذا كان في الآية قولان او اكثر يعرض كل ما قيل فيها واحياناً يتأول في تفسيره وسبب نزول الآية مع بيان اسباب ذلك.
وكتاب “معالم التنزيل في تفسير القران” للبغوي ( ت 510ه / 1116م ) وهو من اجل كتب التفسير وانبلها حاوٍ للصحيح من الاقوال عارٍ عن الغموض والتكلف في التوضيح النص القرآني ، وفيه كثر من الاحاديث النبوية الشريفة الغالب عليها الصحة، وهو تفسير كامل للقران الكريم بالمأثور واشتمل ذكر امر العقيدة وكذلك الفقه وقصصاً وحكماً.
واستفدت من كتاب “الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل” للزمخشري(ت538ه/1143م) وهو احد كتب التفسير والذي سلك فيما يقصد ايضاحه طرق السؤال والجواب ويعنون السؤال بكلمة ( فإن قلت ) والجواب ( قلت ) وكان تفسير هذا الكتاب على مذهب الاعتزال .
ومن الكتب التي اعتمدناها كتاب “مفاتيح الغيب” للرازي( ت 606ه / 1209م) واطلق عليه ايضا اسم التفسير الكبير وهو يعد احد اهم كتب التفسير وهو يعد موسوعة علمية في كتب التفسير وفي مجال الدين عامة وانه اعتمد على التفاسير العقلية للقران والذي يمثل ذروة المحاولات العقلية لفهم القران الكريم وانه تفسير شامل واشتمل على الجمع بين التفسير بالعقل السليم والنقل الصحيح وحوى على مسائل العلوم المختلفة وجاء فيه مناقشات للمعتقدات والمذاهب ، فهو يعد احد اهم كتب التفسير واعظمها واغزرها مادة .
وكتاب “تفسير القران العظيم” لابن كثير ( ت 774ه / 1372م ) وهو احد اهم كتب التفسير والذي فسر القران بالمأثور وكذلك فسر القران بالسنة النبوية الشريفة وبذكر الاحاديث الواردة والاثار المسندة الى اصحابها وجاء فيه شيء من اللغة العربية وعلومها ، وذكر القراءات المختلفة واسباب النزول كما يشتمل على الاحكام الفقهية ، ويضعه البعض بعد تفسير الطبري في الاهمية .
رابعاً: كتب الادب والمعاجم اللغوية :
تعد كتب الادب والمعاجم اللغوية من المصادر المهمة التي شغلت حيزاً كبيراً في دراستنا ولا يمكن لأي باحث الاستغناء عنها اذ انها افادتنا بالكثير من المعلومات طوال مدة الدراسة وخاصة في الالفاظ والتعريفات اللغوية ، وكان ابرزها كتاب “الاغاني” لابي فرج الاصفهاني ( ت 356 ه / 966م ) وهو من اغنى الموسوعات الادبية التي أُلفت في القرن الرابع الهجري واوسعها شهرة لضخامة حجمه ونفاسة قيمته ومحتواه فقد ترجم في هذا المصنف لأكثر شعراء العرب قبل الاسلام وكذلك المخضرمين، واتى في كل فصل بعض الاثار والاخبار وسير واشعار متصلة بأيام العرب المشهورة وقصص الملوك عند العرب قبل الاسلام .
واستفاد الباحث من كتاب ” تهذيب اللغة ” للأزهري ( ت 370ه/980م) والذي يعد من اكثر كتب اللغة دقة وتهذيباً وجمع فيه شتات اللغة بعد ان رحل وقابل وشافه كثير من العرب الموثوقون في عروبتهم من اجل جمع المادة اللغوية .
وكتاب ” المحكم والمحيط الاعظم “ لابن سيدة ( ت 458ه/1065م) هو احد المعجمات الجامعة في اللغة العربية ، والذي سلك في تأليف هذا الكتاب طريقة الخليل بن احمد الفراهيدي ( ت170ه / 786م) تلك الطريقة التي تعتمد على ترتيب الحروف، اذ انه يعد من احسن المعاجم التي التزمت منهج الخليل بن احمد في كتاب العين من حيث ترتيب مواده اذ ظهرت براعة المؤلف حتى ليخيل اليك في بعض الاحيان انك لست في معجم لغوي بل في كتاب من الصرف والنحو لانه استطرد في المسائل النحوية والصرفية .
وكتاب “ لسان العرب ” لابن منظور ( ت711ه / 1311م ) وهو من اهم المعجمات اللغوية واشهرها واطولها كما يعد من اشمل معاجم العربية للألفاظ ومعانيها وقد بلغ عدد المواد اللغوية التي ضمنها هذا الكتاب ثمانين ألف مادة اذ قسم المعجم الى ابواب وقسم كل باب على فصول بعدد حروف الهجاء .
واستفاد الباحث من كتاب ” القاموس المحيط ” للفيروز ابادي(ت817ه/1414م) هو واحد من اهم المعجمات اللغوية والذي يعد من اصح ما ألف في اللغة نقلاً وادقها وصفاً وذلك يعود لتوفيق مؤلفه في علمي اللغة والصرف كما عنى هذا الكتاب بالألفاظ الاصطلاحية في العلوم المختلفة كما اهتم بإيراد المواد من الالفاظ والاعجمي والغريب منها ، وجاء ترتيب الكتاب على الحروف الهجائية الشائعة والذي يسر على الباحثين والقراء طريقة البحث في هذا الكتاب .
خامساً: كتب الطبقات والتراجم :
ومن المصادر التي لا يمكن لأي دراسة تاريخية الاستغناء عنها والافادة منها كتب الطبقات والتراجم نظراً للشخصيات الواردة في الدراسة وكان في مقدمتها كتاب “الاشتقاق” لابن دريد ( ت321ه / 933م ) وهو احد كتب التراجم والذي جاء فيه اسماء القبائل والعمائر وافخاذها وبطونها وكذلك ساداتها وشعرائها وفرسانها ، ولقد بدأ هذا الكتاب باشتقاق اسم النبي(r) ثم اسماء ابائه الى معد بن عدنان وجاء فيه انساب العرب العدنانية والقحطانية وعلى الرغم من انه كتاب تراجم الا انه كان يضم تفسير كثير من الآيات القرآنية والتي يعقب على كل تفسير بقوله : ” الله اعلم ” او نحو ذلك كما يضم تفسير بعض الاحاديث النبوية الشريفة وامثال العرب واشعارها .
ومن الكتب التي اعتمدناها في الدراسة كتاب ” معجم الشعراء ” للمرزباني (ت384ه/994م) والذي جاء فيه ترجمة للشعراء ويذكر غالباً في ترجمته اسم الشاعر ولقبه وكنيته ونسبه وشيئاً يسيراً من شعره واخباره التي تدل على عصره وكثيراً ما نصت الترجمة على عصر الشاعر بكلمة جاهلي او مخضرم او اسلامي ، وقد رتب الكتاب على الحروف الهجائية فبدأ بمن اول اسمه الف وانتهى بمن اول اسمه ياء غير انه لو يرتب الحروف الثواني ولا غيرها الا قليل . ولم يصل الينا هذا الكتاب كاملاً .
وكتاب ” المؤتلف والمختلف ” للدارقطني ( ت 385ه / 995م ) والذي يعد احد اهم كتب الطبقات والتراجم والذي تطرق فيه الى الاسماء والكنى والانساب وان معظم مادة الكتاب في اسماء الاشخاص الين يقع الاشتباه في اسمائهم او كناهم او القابهم ، ولم يكتف بسرد الاسماء والكنى او الالقاب بل يذكر ما يأتلف وما يختلف في الاسماء والقبائل ويتطرق الى اسماء القبائل ومن ينتسب اليها من المحدثين والرواة والمشاهير من الشعراء والفرسان والقواد نقلاً عن أئمة النسابين من كتبهم المشهورة ويستطرد احياناً في ذكر اسماء المواضع ، وقد رتب الكتاب ترتيباً هجائياً على حروف المعجم فابتدأ بالهمزة وانتهى بالياء .
وكتاب” وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ” لابن خلكان(ت681ه/1282م) وهو احد الكتب المهمة في التراجم بالإضافة الى ما وجد فيه من الروايات التاريخية ، ولم يقتصر على طائفة محددة مثل العلماء او الملوك او الوزراء بل تحدث عن كل من له شهرة بين الناس ويقع السؤال عليه فيذكر احواله ويثبت وفاته ومولده ، وقد رتب المؤلف مصنفه حسب حروف الهجاء .
وكتاب ” تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام ” للذهبي (ت748ه/1347م) ويعد بحق احد اهم كتب الطبقات والتراجم وحوى هذا الكتاب على جانب تاريخي ، وذكر فيه وفيات الكبار من الخلفاء والقراء والزهاد والسلاطين والمحدثين والوزراء ومعرفة طبقاتهم ووفاتهم وشيوخهم .
سادساً: كتب الحديث :
يقصد بالحديث أقوال النبي r وأفعاله وأحواله ، وتعد هذه الكتب المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم ، ولذا فهي واجبت الأخذ بها بدليل قوله تعالى:ﭐﱡﭐ … ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ ([3])، ولعل من أهم كتب الحديث التي اعتمدنا عليها بهذه الدراسة وفي مقدمتها كتاب “صحيح البخاري” للبخاري (ت256هـ/869م) ، ويعد من المصنفات في الحديث المجرد ، ومن كتب الجوامع التي احتوت على جميع أبوابه ، ويحتل المرتبة الاولى من بين كتب الصحاح الست واستغرق في كتابته ستة عشر سنه وانتقى احاديثه من 7563 حديث جمعها وهو اول كتاب مصنف في الحديث الصحيح المجرد .
وكتاب ” صحيح مسلم” للإمام مسلم (ت261هـ/874م) ، إذ يعد من أهم كتب الحديث الذي احتوى على جميع أبوابه ، واستغرق في تصنيفه خمس عشر سنة ، ورتب الكتاب ترتيباً دقيقاً ، ويعد احد كتب الجوامع لما يحتوي على جميع ابواب الحديث من عقائد واحكام وادب وتفسير وتاريخ ، ويأتي بعد كتاب صحيح البخاري من حيث الاهمية .
سابعاً: المراجع الحديثة :
كان للمراجع الحديثة من كتب ودوريات دور كبير في اغناء الاطروحة في كثير من جوانب البحث، وخاصة واننا اعتمدنا بالدرجة الاكبر على المراجع وذلك من خلال المعلومات التي وفرتها لنا والآراء والاستنتاجات التي توصلوا اليها اصحاب هذه الكتب ويأتي في مقدمتها كتاب ” المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام “ لجواد علي والذي يعد اضخم عمل اكاديمي في تاريخ العرب والجزيرة في فترة ما قبل ظهور الاسلام، وكتاب ” محاضرات في النصرانية ” لمحمد ابو زهرة والذي يبحث في الادوار التي مرت عليها عقائد النصارى في كتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم، وكتاب ” مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ” لطه باقر، وكانت لكتب رفائيل بابو اسحق دور في اغناء هذه الاطروحة ومنها ” كتاب تاريخ نصارى العراق منذ انتشار النصرانية في الاقطار العراقية الى ايامنا “.
([1])سورة ال عمران، الآية: 85.
([2]) أبو الحسن على بن الحسين (ت 346هـ)، أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران، دار الاندلس، (بيروت-1996م)، ص104.